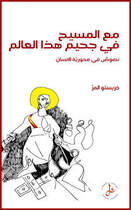With Christ in the Hell of this World: Texts on the Centrality of Human Beings
El Morr C., "La" Publishing, 2021
Amazon website
Book Review
Prof. Assaad Kattan, Centre of Religious Studies at the University of Münster, Germany
In the texts that Christo El Morr puts in our hands through his new book “With Christ in the Hell of this World: Texts on the Centrality of Human Beings,” there are three characteristics that must be noted.
First, in terms of their intellectual position, these texts belong to what we usually call in Christian theology “contextual theology.” Of course, no religious thought is out of context. Every religious thought relates to specific historical circumstances and tries to answer questions that preceded it. Even the texts of the Noble Qur’an, which Muslims consider to be divine, are also linked to the historical context. This is evidenced by the existence of what is known as the “science of the causes of revelation,” which examines the connection of verses with the historical context that “called” for their revelation, so to speak. Consequently, religious thought, and religious literature in general, always refer to a historical context. However, in the twentieth century, a current emerged in Christian theology that emphasized the contextualization of religious thought and re-valued the close relationship between religious discourse and context. Hence, this theology calls for taking the societal and political context seriously, drawing inspiration from it and linking it to the reference religious texts, so that we can arrive at what God wants from us in the present moment and in the place in which we are. The texts of the book in question align with this tradition. In terms of its methodology and objective, it intersects with the attempts made in our region during the last decades to crystallize a theology in the Palestinian context that interrogates the Bible and finds what it can tell us about the Palestinian people’s issue and their suffering, or a theology in the context of common life with Muslims in the Arab world and that it has been developed by Lebanese thinkers in particular. As for the central question posed by El Morr's book, it is related to the message that the Holy Books provide us in relation to the weak on this earth, especially the poor, the marginalized, those subject to injustice, and the oppressed, and how those become a starting point for theological thinking, and what is the exegetical approach that religious thought must adopt in order for it to become directly attentive to their issues. Therefore, the issues of poverty and injustice play a central role in the texts of the bookز
Second, these texts are distinguished by their writer's ability to make extensive use of Human Sciences. It is not self-evident that religious thought reads the Human Sciences and draws benefit from it. Unfortunately, the religious thought, in many of its forms, still shows caution about human sciences; especially about philosophy, history, sociology and psychology, and considers itself, openly or implicitly, as its opponent. Christo El Morr draws inspiration in his book from Human Sciences and uses many of its data and results in building his approach. But he doesn't stop here. Perhaps this is the most important. A religious writer can limit herself /himself to drawing “benefit” from the human sciences, that is, s/he can resort to them and take from them what s/he likes or what supports the validity of her/his opinions, while not questioning the premises of religious thought that need to be questioned. In such case, the religious writer overlooks the humanities and hunts for whatever s/he wants, but remains in her/his ivory tower, so to speak. However, what Christo El Morr offers us in this book is not so. He seeks the intellectual production of the human sciences, including anthropology and statistical sciences, in order to conduct an in-depth review of some of the postulates of religious thought and its premises. We are, therefore, not facing a process of “utilization” in the positive sense, but rather a real interaction. The writer of the texts, subject of this reading, scoops from the human cultural product, which he considers to be storing something of the truth, and re-questions the religious thought in the name of the human cultural product, demanding the development of the religious thought and working on developing it.
Thirdly, I would like to point out to the poetic spirit that characterizes this book. There is no doubt that some of Christo El Morr's texts published here bear remarkable poetic notes. The writer is a poet by nature and experience. Three years ago, he published a collection of poetry entitled "Words for Lostness... A Sweetheart for Exile". But what I would like to stress here is that the texts “With Christ in the hell of this world”, even those those that do not contain “direct” poetic notes, so to speak, carry, in my opinion, the poet’s anxiety and express it. Perhaps this is some of its uniqueness. They are texts that combine theological interest and immersion in the human sciences, and what Abu al-Tayyib al-Mutanabbi referred to, one day, when he described the poet in himself with words that do not age: “I am anxious, as if the wind is beneath me.” What is this anxiety? Where does it start? How does it end? What are its components ? Perhaps they are questions that we will never reach definitive answers to. It is suffice for me to say that it is a kind of anxiety associated with the search for meaning. Poetry, in the end, is a search for the meaning of human existence and a touch of it.
El Morr C., "La" Publishing, 2021
Amazon website
Book Review
Prof. Assaad Kattan, Centre of Religious Studies at the University of Münster, Germany
In the texts that Christo El Morr puts in our hands through his new book “With Christ in the Hell of this World: Texts on the Centrality of Human Beings,” there are three characteristics that must be noted.
First, in terms of their intellectual position, these texts belong to what we usually call in Christian theology “contextual theology.” Of course, no religious thought is out of context. Every religious thought relates to specific historical circumstances and tries to answer questions that preceded it. Even the texts of the Noble Qur’an, which Muslims consider to be divine, are also linked to the historical context. This is evidenced by the existence of what is known as the “science of the causes of revelation,” which examines the connection of verses with the historical context that “called” for their revelation, so to speak. Consequently, religious thought, and religious literature in general, always refer to a historical context. However, in the twentieth century, a current emerged in Christian theology that emphasized the contextualization of religious thought and re-valued the close relationship between religious discourse and context. Hence, this theology calls for taking the societal and political context seriously, drawing inspiration from it and linking it to the reference religious texts, so that we can arrive at what God wants from us in the present moment and in the place in which we are. The texts of the book in question align with this tradition. In terms of its methodology and objective, it intersects with the attempts made in our region during the last decades to crystallize a theology in the Palestinian context that interrogates the Bible and finds what it can tell us about the Palestinian people’s issue and their suffering, or a theology in the context of common life with Muslims in the Arab world and that it has been developed by Lebanese thinkers in particular. As for the central question posed by El Morr's book, it is related to the message that the Holy Books provide us in relation to the weak on this earth, especially the poor, the marginalized, those subject to injustice, and the oppressed, and how those become a starting point for theological thinking, and what is the exegetical approach that religious thought must adopt in order for it to become directly attentive to their issues. Therefore, the issues of poverty and injustice play a central role in the texts of the bookز
Second, these texts are distinguished by their writer's ability to make extensive use of Human Sciences. It is not self-evident that religious thought reads the Human Sciences and draws benefit from it. Unfortunately, the religious thought, in many of its forms, still shows caution about human sciences; especially about philosophy, history, sociology and psychology, and considers itself, openly or implicitly, as its opponent. Christo El Morr draws inspiration in his book from Human Sciences and uses many of its data and results in building his approach. But he doesn't stop here. Perhaps this is the most important. A religious writer can limit herself /himself to drawing “benefit” from the human sciences, that is, s/he can resort to them and take from them what s/he likes or what supports the validity of her/his opinions, while not questioning the premises of religious thought that need to be questioned. In such case, the religious writer overlooks the humanities and hunts for whatever s/he wants, but remains in her/his ivory tower, so to speak. However, what Christo El Morr offers us in this book is not so. He seeks the intellectual production of the human sciences, including anthropology and statistical sciences, in order to conduct an in-depth review of some of the postulates of religious thought and its premises. We are, therefore, not facing a process of “utilization” in the positive sense, but rather a real interaction. The writer of the texts, subject of this reading, scoops from the human cultural product, which he considers to be storing something of the truth, and re-questions the religious thought in the name of the human cultural product, demanding the development of the religious thought and working on developing it.
Thirdly, I would like to point out to the poetic spirit that characterizes this book. There is no doubt that some of Christo El Morr's texts published here bear remarkable poetic notes. The writer is a poet by nature and experience. Three years ago, he published a collection of poetry entitled "Words for Lostness... A Sweetheart for Exile". But what I would like to stress here is that the texts “With Christ in the hell of this world”, even those those that do not contain “direct” poetic notes, so to speak, carry, in my opinion, the poet’s anxiety and express it. Perhaps this is some of its uniqueness. They are texts that combine theological interest and immersion in the human sciences, and what Abu al-Tayyib al-Mutanabbi referred to, one day, when he described the poet in himself with words that do not age: “I am anxious, as if the wind is beneath me.” What is this anxiety? Where does it start? How does it end? What are its components ? Perhaps they are questions that we will never reach definitive answers to. It is suffice for me to say that it is a kind of anxiety associated with the search for meaning. Poetry, in the end, is a search for the meaning of human existence and a touch of it.
«مع المسيح في جحيم هذا العالم»: خريستو المرّ يسائل اللاهوت بالعلم والشعر
الأحد 11 تموز 2021
أسعد قطّان
في النصوص التي يضعها خريستو المرّ بين أيدينا عبر كتابه الجديد «مع المسيح في جحيم هذا العالم: نصوص في محوريّة الإنسان» خصائص ثلاث لا بدّ من التوقّف عندهاأوّلاً، تنتمي هذه النصوص، من حيث موقعها الفكريّ، إلى ما ندعوه في العادة في اللاهوت المسيحيّ «اللاهوت السياقيّ» (Contextual Theology). بالطبع، ليس ثمّة فكر دينيّ خارج السياق. فكلّ فكر دينيّ يتّصل بظروف تاريخيّة معيّنة ويحاول الإجابة عن أسئلة سابقة له. حتّى نصوص القرآن الكريم، التي يعتبرها المسلمون منزلةً، هي أيضًا مرتبطة بالسياق التاريخيّ. ويدلّ على ذلك وجود ما يُعرف بـِ «علم أسباب النزول»، وهو علم قائم في ذاته يبحث في ارتباط الآيات بالسياق التاريخيّ الذي «دعا» إلى نزولها، إذا جاز التعبير. وتالياً، الفكر الدينيّ، والأدب الدينيّ بعامّة، يحيلان دوماً إلى سياق تاريخيّ. ولكن في القرن العشرين نشأ تيّار في اللاهوت المسيحيّ شدّد على سياقيّة الفكر الدينيّ وأعاد تثمين العلاقة الوثيقة بين الخطاب الدينيّ والسياق. ومن ثمّ، فإنّ هذا اللاهوت يدعو إلى أخذ السياق المجتمعيّ والسياسيّ على محمل الجدّ واستلهامه وربطه بالنصوص الدينيّة المرجعيّة، بحيث يمكننا الخلوص إلى ما يريده الله منّا في اللحظة الراهنة وفي المكان الذي نحن قائمون فيه. إنّ نصوص الكتاب الذي نحن في صدده قائمة في هذا الخطّ البيانيّ. وهي، من حيث منهجيّتها وهدفها، تتقاطع مع محاولات قامت في منطقتنا إبّان العقود الأخيرة لبلورة لاهوت في السياق الفلسطينيّ يستنطق الكتاب المقدّس ويتلمّس ما يمكن أن يقوله لنا حيال قضيّة الشعب الفلسطينيّ ومعاناته، أو لاهوت في سياق الحياة المشتركة مع المسلمين في العالم العربيّ عكف على تطويره مفكّرون لبنانيّون على وجه الخصوص. أمّا السؤال المركزيّ الذي يطرحه الكتاب الذي نحن في صدده، فيتّصل بالرسالة التي تزوّدنا بها الكتب المقدّسة حيال المستضعفين في الأرض، ولا سيّما الفقراء والمهمّشين والمظلومين والمقهورين، وكيفيّة صيرورة هؤلاء منطلقاً للتفكير اللاهوتيّ، وماهيّة المقاربة التفسيريّة التي يجب اعتمادها كي يصبح الفكر الدينيّ معنيّاً بهم مباشرةً ومنتبهاً إلى قضاياهم. لذا، فإنّ مسألتي الفقر والمظلوميّة تضطلعان بدور محوريّ في نصوص الكتاب
ثانياً، تمتاز هذه النصوص بقدرة كاتبها على الاستفادة الكثيفة من العلوم الإنسانيّة. ليس من البديهيّ أن يعبّ الفكر الدينيّ من العلوم الإنسانيّة. فهذا الفكر، ويا للأسف، ما زال يبدي في كثير من تشكّلاته حذراً حيال هذه العلوم، ولا سيّما الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس، معتبراً ذاته، على نحو معلن أو مبطن، خصماً لها. خريستو المرّ يستلهم في كتابه العلوم الإنسانيّة ويستعيد كثيراً من معطياتها ونتائجها في بناء مقاربته. ولكنّه لا يتوقّف هنا. ولعلّ هذا هو الأهمّ. فالكاتب الدينيّ يستطيع أن «يستفيد» من العلوم الإنسانيّة فحسب، أي أن يلجأ إليها ويأخذ منها ما يحلو له أو ما يدعم صحّة آرائه، ولكن من دون أن يفضي هذا إلى مساءلة لمنطلقات الفكر الدينيّ التي تحتاج إلى مساءلة. في هذه الحال، يطلّ الكاتب الدينيّ على العلوم الإنسانيّة ويتصيّد منها ما يشاء، ولكنّه يبقى في برجه العاجيّ، إذا جاز القول. غير أنّ ما يقدّمه لنا خريستو المرّ في كتابه هذا ليس كذلك. فهو يستنجد بالإنتاج الفكريّ للعلوم الإنسانيّة، بما فيها الأنثروبولوجيا والعلوم الإحصائيّة، كي يقوم بمراجعة معمّقة لبعض مسلّمات الفكر الدينيّ ومنطلقاته. نحن، إذاً، لسنا أمام عمليّة «استفادة» بالمعنى الوضعيّ، بل أمام تفاعل حقيقيّ. فكاتب النصوص موضوع هذه المطالعة يغرف من المنتَج الثقافيّ الإنسانيّ، الذي يعتبر أنّه يختزن شيئاً من الحقيقة، ويعيد مساءلة الفكر الدينيّ باسم هذا المنتَج مطالباً بتطويره وعاملاً على تطويره
ما أوّد الإشارة إليه، ثالثاً، هو الحسّ الشعريّ الذي يتّصف به هذا الكتاب. لا شكّ في أنّ بعضاً من نصوص خريستو المرّ المنشورة هنا تحمل نفحات شعريّةً لافتة. فالكاتب شاعر بالفطرة والتمرّس. وقد نشر، قبل ثلاث سنوات، ديواناً شعريّاً بعنوان «كلمات للضياع... حبيبة للمنفى». ولكنّ ما أودّ التشديد عليه هنا هو أنّ نصوص «مع المسيح في جحيم هذا العالم»، حتّى تلك التي لا تنطوي على نفحات شعريّة «مباشرة»، إذا جاز التعبير، تحمل، في رأيي، قلق الشاعر وتفصح عنه. ولعلّ هذا يشكّل بعضاً من فرادتها. إنّها نصوص تجمع بين الاهتمام اللاهوتيّ والغوص على العلوم الإنسانيّة وما أشار إليه أبو الطيّب المتنبّي، ذات يوم، حين وصف الشاعر الذي فيه بكلمات لا تشيخ: «على قلق كأنّ الريح تحتي». ما هو هذا القلق؟ أين يبدأ؟ كيف ينتهي؟ ما هي عناصره ومكوّناته؟ لعلّها أسئلة لن نتوصّل يوماً إلى استنباط أجوبة نهائيّة عنها. أكتفي هنا بالقول إنّه نوع من القلق الذي يرتبط بالبحث عن المعنى. فالشعر، في نهاية المطاف، بحث عن معنى الوجود الإنسانيّ وتلمّس له
الأحد 11 تموز 2021
أسعد قطّان
في النصوص التي يضعها خريستو المرّ بين أيدينا عبر كتابه الجديد «مع المسيح في جحيم هذا العالم: نصوص في محوريّة الإنسان» خصائص ثلاث لا بدّ من التوقّف عندهاأوّلاً، تنتمي هذه النصوص، من حيث موقعها الفكريّ، إلى ما ندعوه في العادة في اللاهوت المسيحيّ «اللاهوت السياقيّ» (Contextual Theology). بالطبع، ليس ثمّة فكر دينيّ خارج السياق. فكلّ فكر دينيّ يتّصل بظروف تاريخيّة معيّنة ويحاول الإجابة عن أسئلة سابقة له. حتّى نصوص القرآن الكريم، التي يعتبرها المسلمون منزلةً، هي أيضًا مرتبطة بالسياق التاريخيّ. ويدلّ على ذلك وجود ما يُعرف بـِ «علم أسباب النزول»، وهو علم قائم في ذاته يبحث في ارتباط الآيات بالسياق التاريخيّ الذي «دعا» إلى نزولها، إذا جاز التعبير. وتالياً، الفكر الدينيّ، والأدب الدينيّ بعامّة، يحيلان دوماً إلى سياق تاريخيّ. ولكن في القرن العشرين نشأ تيّار في اللاهوت المسيحيّ شدّد على سياقيّة الفكر الدينيّ وأعاد تثمين العلاقة الوثيقة بين الخطاب الدينيّ والسياق. ومن ثمّ، فإنّ هذا اللاهوت يدعو إلى أخذ السياق المجتمعيّ والسياسيّ على محمل الجدّ واستلهامه وربطه بالنصوص الدينيّة المرجعيّة، بحيث يمكننا الخلوص إلى ما يريده الله منّا في اللحظة الراهنة وفي المكان الذي نحن قائمون فيه. إنّ نصوص الكتاب الذي نحن في صدده قائمة في هذا الخطّ البيانيّ. وهي، من حيث منهجيّتها وهدفها، تتقاطع مع محاولات قامت في منطقتنا إبّان العقود الأخيرة لبلورة لاهوت في السياق الفلسطينيّ يستنطق الكتاب المقدّس ويتلمّس ما يمكن أن يقوله لنا حيال قضيّة الشعب الفلسطينيّ ومعاناته، أو لاهوت في سياق الحياة المشتركة مع المسلمين في العالم العربيّ عكف على تطويره مفكّرون لبنانيّون على وجه الخصوص. أمّا السؤال المركزيّ الذي يطرحه الكتاب الذي نحن في صدده، فيتّصل بالرسالة التي تزوّدنا بها الكتب المقدّسة حيال المستضعفين في الأرض، ولا سيّما الفقراء والمهمّشين والمظلومين والمقهورين، وكيفيّة صيرورة هؤلاء منطلقاً للتفكير اللاهوتيّ، وماهيّة المقاربة التفسيريّة التي يجب اعتمادها كي يصبح الفكر الدينيّ معنيّاً بهم مباشرةً ومنتبهاً إلى قضاياهم. لذا، فإنّ مسألتي الفقر والمظلوميّة تضطلعان بدور محوريّ في نصوص الكتاب
ثانياً، تمتاز هذه النصوص بقدرة كاتبها على الاستفادة الكثيفة من العلوم الإنسانيّة. ليس من البديهيّ أن يعبّ الفكر الدينيّ من العلوم الإنسانيّة. فهذا الفكر، ويا للأسف، ما زال يبدي في كثير من تشكّلاته حذراً حيال هذه العلوم، ولا سيّما الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس، معتبراً ذاته، على نحو معلن أو مبطن، خصماً لها. خريستو المرّ يستلهم في كتابه العلوم الإنسانيّة ويستعيد كثيراً من معطياتها ونتائجها في بناء مقاربته. ولكنّه لا يتوقّف هنا. ولعلّ هذا هو الأهمّ. فالكاتب الدينيّ يستطيع أن «يستفيد» من العلوم الإنسانيّة فحسب، أي أن يلجأ إليها ويأخذ منها ما يحلو له أو ما يدعم صحّة آرائه، ولكن من دون أن يفضي هذا إلى مساءلة لمنطلقات الفكر الدينيّ التي تحتاج إلى مساءلة. في هذه الحال، يطلّ الكاتب الدينيّ على العلوم الإنسانيّة ويتصيّد منها ما يشاء، ولكنّه يبقى في برجه العاجيّ، إذا جاز القول. غير أنّ ما يقدّمه لنا خريستو المرّ في كتابه هذا ليس كذلك. فهو يستنجد بالإنتاج الفكريّ للعلوم الإنسانيّة، بما فيها الأنثروبولوجيا والعلوم الإحصائيّة، كي يقوم بمراجعة معمّقة لبعض مسلّمات الفكر الدينيّ ومنطلقاته. نحن، إذاً، لسنا أمام عمليّة «استفادة» بالمعنى الوضعيّ، بل أمام تفاعل حقيقيّ. فكاتب النصوص موضوع هذه المطالعة يغرف من المنتَج الثقافيّ الإنسانيّ، الذي يعتبر أنّه يختزن شيئاً من الحقيقة، ويعيد مساءلة الفكر الدينيّ باسم هذا المنتَج مطالباً بتطويره وعاملاً على تطويره
ما أوّد الإشارة إليه، ثالثاً، هو الحسّ الشعريّ الذي يتّصف به هذا الكتاب. لا شكّ في أنّ بعضاً من نصوص خريستو المرّ المنشورة هنا تحمل نفحات شعريّةً لافتة. فالكاتب شاعر بالفطرة والتمرّس. وقد نشر، قبل ثلاث سنوات، ديواناً شعريّاً بعنوان «كلمات للضياع... حبيبة للمنفى». ولكنّ ما أودّ التشديد عليه هنا هو أنّ نصوص «مع المسيح في جحيم هذا العالم»، حتّى تلك التي لا تنطوي على نفحات شعريّة «مباشرة»، إذا جاز التعبير، تحمل، في رأيي، قلق الشاعر وتفصح عنه. ولعلّ هذا يشكّل بعضاً من فرادتها. إنّها نصوص تجمع بين الاهتمام اللاهوتيّ والغوص على العلوم الإنسانيّة وما أشار إليه أبو الطيّب المتنبّي، ذات يوم، حين وصف الشاعر الذي فيه بكلمات لا تشيخ: «على قلق كأنّ الريح تحتي». ما هو هذا القلق؟ أين يبدأ؟ كيف ينتهي؟ ما هي عناصره ومكوّناته؟ لعلّها أسئلة لن نتوصّل يوماً إلى استنباط أجوبة نهائيّة عنها. أكتفي هنا بالقول إنّه نوع من القلق الذي يرتبط بالبحث عن المعنى. فالشعر، في نهاية المطاف، بحث عن معنى الوجود الإنسانيّ وتلمّس له